مظاهر حضاريّة في المدن الإسلاميّة
الإضاءة
عرف العرب قبل الإسلام جميع وسائل وطرائق الإضاءة المعروفة حتّى عهدهم، ولا سيما أولئك الذين كانوا يعيشون منهم على أطراف الجزيرة العربية في اليمن والأحساء والبحرين والحجاز، أو في مشارف الشام وحافّة السواد العراقي.
وكان أكثرها شيوعاً: وسائل الإنارة بالزيوت، ثمّ بالشموع. وقد يكونون قد عرفوا نوعاً من الإنارة بالنفط الذي استخدمه الساسانيون على حوافي العراق. أما النار المطلقة فكانت لسكان البادية وقد يوقدونها لقِرى الضِّيفان، ولعقد الأحلاف، ولاستدعاء النَّجدات عند الحرب، أو للسَّمَر في الليل. وقد كانت النار على أي حال أساس كل عمليات الإضاءة، وكان يستخدم فيها سعف النخل..
ولم يزد العهد الإسلامي شيئاً على مواد الإضاءة الثلاث: الزيت، والشمع، والنفط، ولكنه تفنّن في إخراج الوسائل التي تحتضنها والأدوات التي تبرز بها النار وتُحمل من مكان لآخر.
1 ـ الأسرجة:
كانت هي الشائعة في طول العالم الإسلاميّ وعرضه، وهي ليست أكثر من وعاء فيه زيت وله فتيل. وزيت الزيتون متوفر في أنحاء المملكة الإسلامية في الأندلس وإفريقية والشام وفارس. وكان السراج في أول الأمر يستعمل للبيوت كما للمساجد الأولى وفي القصور كما لدى الطبقات المتواضعة. وقد روي عن الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله أنه كان يوصي إذا أراد أحدٌ الرقادَ أن يغلق بابه، ويُوكئ سِقاءه، ويخمّر إناءه، ويُطفئ سراجه (1). كما ذكروا أن تميماً الدارمي (صاحب وقف الدارى في الخليل) قَدِم مسجد الرسول في خمسة من غلمانه فأسرج مسجده بالقناديل والزيت. وكانت قبلُ تُضاء بسعف النخيل (2).
وتساوى في استخدام السراج للإضاءة: الخلفاء والعامة، وكان الفرق فقط في نوع السراج من الطين أو الزجاج أو الخزف أو خلائط النحاس، وفي الكبر والصغر، وفي الزخرفة التي تقع عليه.
وقد استخدم في العهد الأموي والعباسي على السواء حتّى العهد الفاطمي والمملوكي. وكان المنصور يقرأ عليه رسائل الدولة وهو ساهر وقد يخرج في الفجر وبين يديه خادم بمصباح خوفَ العدوان عليه، كما كان الجاحظ يقرأ على السراج في دكاكين الوراقين حين يستأجرها في الليل لقراءة الكتب. وابن سينا يقول عن حياته الأولى في بخارى أواخر القرن الرابع «... وكنت أرجع بالليل إلى داري وأضع السراج بين يديّ وأشتغل بالقراءة والكتابة...» (3). وكانت تنار به دمشق وبغداد وقرطبة والقيروان، كما تنار به بيوت القدس وشيراز وهَمَدان وبخارى وسمرقند.
غير أن العصر العباسي أتى في الأسرجة ببعض البِدع، فثمة مَن ضمّ بالطين ثلاثة أسرجة بعضها فوق بعض وجعل لها ثلاث ذبالات تتقد معاً، كالذي فعله حمّاد الراوية فلامه أصدقاؤه على إسرافه في اقتناء تلك المنارة!
وكان السلطان هو الذي يتكفل بإضاءة المساجد والمؤسسات الدينية من مدارس وزوايا ودور حديث. وقد ذُكر أن المعتصم سنة 219 هـ سكان أول من أنفَطَ وأسرَجَ بين المأزمين في طريق عرفة.
وتلألأت الأنوار في الحرم المكي والمسجد النبوي خيفةَ أن يعدو اللصوص على المعتمرين (4)، فهي مَطْرَدة للشيطان ومَذَبّة للهوامّ ومُدِلّة على اللصوص.
أما شوارع المدن وأزقتها فكان أهلها يُلزَمون بإضاءتها وبخاصة في مواطن الشبهات. يقول ناصر خسرو إنه رأى بمصر أسواقاً وأزقة ضيقة تظل فيها القناديل مشتعلة بشكل دائم، لأن نور الشمس لا يصل أبدا إليها، وهي أزقة لا ينقطع سير الناس إليها (5). وقد ذكروا أن شوارع الربض في شرقيّ قرطبة كانت مُنارة في الليل بالمصابيح التي بلغ من كثرتها أن جلست النسوة يكتبن المصاحف بالخط الكوفي... وتمتد الأسرجة يستضيء بها الناس ثلاثة فراسخ (6) وكان أصحاب المراكب يلزمون بإضاءتها ليلاً.
وقد ظلت ابتكارات أولاد موسى بن شاكر في الأسرجة نظرية مكتوبة على الورق، وقد يكونون قد جرّبوها ولكنها لم تجاوز بعد ذلك بطون كتابهم عن (الحِيَل) كالسراج الذي لا يزال ممتلئاً أبداً بالزيت، وسراج الله الذي يخرج الفتيل لنفسه ويملأ بالزيت لنفسه. والسراج الذي يخرج الفتيل فقط بذاته. والسراج الذي لا ينطفئ في الريح العاصف. وقد رسموا أشكالها وبقيت أشكالاً لم يجد فيها الناس الوسيلة السهلة للإنارة.
2 ـ القناديل (أو المصابيح):
كانت خطوة متقدمة على السراج. وهي ببساطة طريقة لإضافة الزجاج الشفاف حول ذبالة السراج ثمّ تعليقه إن شاء حامله بدَلَ إثباته الدائم على قاعدة. وقد كانت القناديل معروفة، ولكنها لم تصبح مبذولة للناس بسبب تكاليفها، فاختصت بها دور العبادة، كما حُملت للكبراء والموسرين في سُراهم ليلاً بالشوارع، ووُضِعت على أبوابهم. ويذكرون أن المأمون هو الذي أمر بالاستكثار من المصابيح في المساجد وكلف كاتبه أحمد بن يوسف بن القاسم اللبان بذلك إلى جميع عمال الدولة فكتب: «إن في ذلك أمناً للسابلة، وإضاءة للمتهجهدين ونفياً لمضانّ الريب...» (7).
كما يذكر الترشحي في تاريخ بخارى أن الفضل بن يحيى البرمكي قد سبق المأمون في ذلك خلال ولايته على خراسان، فكان أول من أمر بزيادة القناديل في المساجد في إمارته، في شهر رمضان(8).
اهتم ابن طولون ـ حين بنى مسجده الضخم في القطائع ـ أن يضيئه، فعلّق بسقفه السلاسل النحاسية المفرغة والقناديل المحكمة... (9).
وهكذا تطورت وتوسعت صناعة القناديل بعد ذلك، ولعب الترف في مادتها كما لعب الفن في تزيينها، فصار بعضها من الزجاج وأركان بعضها من الفضة وبعض من الذهب، وأخذت زينتها من الزخرف والتكفيت، وجعلت سلاسلها التي تُعلّق بها من مختلف المعادن بما فيها الفضة والذهب... وقامت لها في المدن الكبرى أسواق خاصة، كسوق القناديل بمصر الذي ذكره ناصر خسرو الرحالة قائلاً: «رأيتُ في هذا السوق من الطرائف والتحف ما لم أره في أي سوق آخر في العالم. ويوجد في هذا السوق نفائس من كل أقطار الأرض... ورأيت في داخل هذا السوق آلات دقيقة الصنعة... وصنّاعاً ينحتون البلّور بخفّة ومهارة تستوقفان النظر. والبلور مجلوب من المغرب... وفي مصر نوع من البلور اللطيف الشفاف يفوق هذا البلد المغربي. ورأيت في سوق القناديل نوعاً من العاج يُجلب من زنجبار يزيد وزنه على مائتي رطل...» (10).
وذكر هذا الرحالة عن قبة الصخرة في القدس أنه: «تنتشر القناديل الفضية في فضاء القبة، ويحمل كل قنديل اسم واهبه لهذا المقام القدسي. وقد رأيت من بين تلك القناديل قنديلاً يحمل اسم سلطان مصر. ولقد حسبت الكمية الفضية الموجودة في هذا المكان فوجدتها ألف رطل من الفضة موزّعة في ثنايا القبة... ويعلو الصخرة قنديل فضي معلّق ينحدر من سلاسل فضية تزيده اشتعالاً وتلقي على القبة مزيداً من الهيبة والجلال» (11).
وذكر الرحالة نفسه أيضاً: «أن الحاكم بأمر الله اشترى مسجد عمرو بن العاص من أحفاده وأضاف إليه زيادات جميلة وعجيبة، وأمر أن يُزيّن المسجد بقناديل فضية. وقد رأيت بعضها ـ وهي ذات ستّ عشرة ـ زاوية آية في الروعة والهندسة، ويُكتفى بإضاءة جزء من تلك القناديل في الأيّام العادية، فإذا كانت الأعياد أُضيئت جميع تلك المصابيح (وهي 700)، فيسبح الجامع في بحر من النور. ويقولون إن زنة تلك المصابيح خمسة وعشرون قنطاراً من الفضة، كل قنطار وزنه مائة رطل، وكل رطل زنة 144 درهماً فضياً. يقولون إنهم حين حاولوا إدخال هذه القناديل إلى المسجد لم يتسع لها أي باب من أبواب المسجد لعِظَمها، حتّى هدموا أحد الأبواب توسيعاً للمصابيح ثمّ أعادواالباب إلى مكانه الأول» (12) كان ذلك سنة 403 هـ/1012م.
«وكان من رسوم الشام إبقاء القناديل في مساجدهم على الدوام يعلقونها بالسلاسل مثل مكة»
(13). وقد نهب الصليبيون قناديل قبة الصخرة والمسجد الأقصى وباعوها كِسَر فضة.
وقد رأى ابن جُبَير (حوالي سنة 570هـ/1174م) الكثير من القناديل المعلقة في الكعبة تُوقد كل ليلة(14)، وبعضها في أعلى المنارات. ويعد صاحب الاستبصار منها في المسجد النبوي بالمدينة 284 قنديلاً كما عدّ القزويني ـ بعد تحرير القدس ـ في المسجد الأقصى 1500 قنديل و 464 قنديلاً في قبة الصخرة. وكانت سلاسل القناديل تعلق في السقوف، لكل قنديل ثلاث سلاسل إلى خمسين أو أكثر. ويذكر ابن الفقيه أنه أحصى سلاسل مصابيح الجامع بدمشق فكانت ستمائة سلسلة من الذهب(15).
وقد تطورت صناعة القناديل كثيراً في العهد الإسلامي، فإذا كانوا قد جمعوا بعض الأسرجة إلى بعضها فقد كان إمكان جمع القناديل أوسع بسبب ما يمسكها من المعادن، ولأنها على الأغلب ثابتة معلقة. وبهذا الشكل ظهرت صناعة التنانير، والثريات التي تجمع عشرات المصابيح في مجموعة واحدة.
وكانت المصابيح التي ذكر ناصر خسرو أن الحاكم بأمر الله أهداها سنة 403هـ لمسجد عمرو تنوّراً كبيراً فيه مائة ألف درهم من الفضة. وذكر أنه كان فيه عشر مناطق، في كل منطقة 120 بزاقة، وفيه سَروات بارزة مثل النخيل، في كل واحدة عشر بزاقات، تقرب عدة ذلك من ثلاثمائة ومعلقة بأسفله مائة قنديل نجومية... (16). وعلق في قبة الصخرة تنوّر فيه أكثر من خمسمائة قنديل ثمّ سقط سنة 454هـ/ 1061م فتطيّر الناس وقالوا: «ليكونن في الإسلام حادث عظيم»!
ويبدو أن ما كان يسمى في المشرق بالتنوّر كان يدعى في المغرب بالثريّا؛ تشبيهاً لها بنجوم الثريا لولا أن التنور المشرقي كان على هيئة التنور والثريا في المغرب على شكل منائر من البلّور. وقد وصف الشريف الإدريسي ثُريّات مسجد قُرطبة، وعددها يزيد على 113 ثريّا، وأكبرها تحمل ألف مصباح وأصغرها 12 مصباحاً (17).
وكان في قصر الحمراء ثريات من البرونز من صنع الأندلس، ما يزال بعضها باقياً في متحف مدريد.
وثمة في جامع القيروان ثلاث ثريات من عهد المعزّ الفاطمي سنة 345هـ/956م. وقد قلدها الموحدون أيّام الناصر الموحدي سنة 600هـ/1204م بأخرى من مثلها سمّوها «الشاخصة»، وعدد قناديلها 520 قنديلاً وقطرها أكثر قليلاً من مترين. وأما الصغرى فقد كُسيت بثلاث حاملات للمصابيح. وفي جامع تازة ثريا تحمل 514 مصباحاً وتزن أكثر من 32 قنطاراً (18). وثمة نماذج أخرى من العصر المملوكي موزعة بين المتحف الإسلامي في القاهرة ومتحف دمشق وغيرها.
وقد وصف ابن صاحب الصلاة المؤرخ المغربي أيّام الموحدين صوراً معبرة عن التنوّر وأضوائه المتلألئة وأثرها في النفوس حين قدم مسجد قرطبة الجامع لحضور الاحتفال بليلة القدر، ووصف الفتيلة التي رُفعت على مئذنة الجامع وفي داخلها الشموع لتزيينها (19).
واستعملت في المدن الإسلاميّة مع القناديل: المشكاة، وهي السراج يوضع في وعاء زجاجي مزيّن ويعلّق كالمصباح. ويبدو أن صناعتها والاستصباح بها في المساجد شاع كثيراً في العصر المملوكي، فثمة منها أعداد كثيرة في المتاحف. وزجاجها الملون الذي تغلب فيه الزرقة كان يحمل الزخارف والكتابات والصور على الزجاج، وغالباً ما يحمل الآيات القرآنية. وقد يطعّم الزجاج بالمِينا. وقد تصنع المشكاة كلها من الخزف أو من النحاس المكفّت بالذهب والفضة.
3 ـ الشمع:
كان في استخدام الشمع في الإضاءة نوع من الترف؛ لارتفاع ثمنه، ولاعتياد الناس على تقديمه أو حمله في المواكب والاحتفالات. وكان يباع بالوزن، واشتهرت إصبهان بإنتاجه، وكانت تحمل في جملة خراجها السنوي إلى السلطان ألف رطل منه (20).
وكانت الشموع تُصنع حسب حاجة المشترين طولاً وضخامة ووزناً، كما تتنوع أنواعاً وتتلوّن بألوان شتّى. وكانت قبل الإسلام ترافق المواكب الكنَسية أو تُهدى للمعابد، وقد استخدمها بعض ملوك الحيرة في موكبه كما استخدمها الحكّام الأمويون. فكان يُمشى بين أيديهم بالشموع الطوال التي قد يصل طول الواحدة منها ثلاثة أشبار (قرابة 60 ـ 70سم) ويتجاوز وزنها ستة أرطال (21)، كالشمع الذي كان يُمشى فيه بين يدَي يزيد بن عبدالملك. ويذكرون أن الوليد بن يزيد اتخذ الشموع الغلاظ المنوية (التي يبلغ وزنها المن أو الرطلين).
وكان للشموع أنوار كالمصابيح والقناديل تجمعها مجموعة في إطار واحد أو اثنين أو ثلاثة. وتثبّت الشموع فيها بأشواك أو بركائز، ويمكن في هذه الحالة تعليقها في المعابد وغرف القصور. أما الشموع المحمولة فكانت تحتاج إلى الشَّماعِد التي تمتدّ من الوعاء الصغير الذي يحمل شمعة واحدة إلى الشمّاعة ذات الفروع المتعددة. وتصنع الشماعد من الحديد والنحاس والبرونز والذهب والفضة، كما قد تصنع من الخزف. فالرشيد ليلة بنى بزبيدة أمر بحمل الشموع بأنوار من الذهب (22). وفي عرس المعتضد على قطر الندى كانت الأنوار من الفضة وواحد من الذهب (23). على أن المنصور كان يقرأ على السراج أو على شمعة في تور، وكذلك خلفاؤه.
بَيْد أن الإضاة بالشموع لم تكن بعد قد شاعت، فكانت مجالس الخلفاء والكبراء والطبقة الميسورة وليالي المساجد الكبيرة هي التي تضاء بالشموع منذ العصر الأموي، لأنه يكلف أضعاف الأسرجة. وقد قطع عمر بن عبدالعزيز أرزاق الشمع عن ولاة بني أمية، ولمّا طلب أبو بكر محمد بن محمد بن عمرو والي المدينة منه معاودة إطلاق هذه الأرزاق شَهَره وأمره ألا يعاوده في هذا الأمر.
غير أن استخدام الشمع انتشر وزاد بعد ذلك في جميع أنحاء العالم الإسلامي من المشرق إلى الأندلس، بعد أن كثرت وتنوعت صناعته منذ أواخر القرن الثاني. فكان الرشيد يطلب مِن حاجبه أن يستكثر من الشموع إذا انتظم مجلس السَّمَر في قصره ببغداد. وكان الأفضل الجمالي يعقد مجلس سَمَره على النيل والشموع تزهر بين يديه. ومحمد بن محمد بن نصر في غرناطة كان السمر والمجالسة عنده في كنف الشموع الضاحكة والأنوار اللاطونية (24). ونجد في ما بقي من أخبار نفقات الخلفاء والمساجد أثمان الشموع، وهي زهيدة إذا قيست بمقدار ثرواتهم وما ينفقون، فقد ذُكر أن المتوكل ـ وكان مشهوراً بالاسراف الشديد وبناء القصور الكثيرة ـ بلغ مجموع ما أنفقه على الشموع في السنة مائتي ألف درهم، في حين كان ثمن الشمع والزيت ـ للأسرجة ـ زمن المعتضد ستة دنانير وثلثي الدينار سنوياً (25). وحين عُيّن ابن الفرات (علي بن محمد) للوزارة زمن المقتدر سنة 304هـ زاد ثمن الشمع قيراطاً في كل مَنّ، لأن كل مَن جاءه مهنئاً ما خرج إلا وفي يده شمعة منوية، ودرج منصوري (ثوب). ولكن الوزير علي بن ـ عيسى وكان مقتصداً ـ أمر متولّي زمام نفقاته أن ينقص ما يصرف للفرّاشين من الزيت والشمع؛ لأن الليل قد نقص ثلاث ساعات (26).
ولكن هذا كله لا يدل على أكثر من الحرص في النفقة، فالتجار الصغار والميسورون كانوا يجدونه بسهولة ويستخدمونه بسبب كثرة استيراده، حتّى صارت له أسواق خاصة في المدن الإسلامية كسوق الشمّاعين في القاهرة، وكان يباع فيه في كل ليلة من الشمع بمال جزيل.
وكان شهر رمضان موسماً عظيماً فيه؛ لكثرة ما يُشترى ويُكترى من الشموع الموكبية التي تَزِن الواحدة منها عشرة أرطال فما دونها من المزهّرات العجيبة الزيّ المليحة الصنعة، ومن الشمع الذي يُحمل على العِجل ويبلغ وزن الواحدة منها عشرة أرطال وما فوق ذلك (27). ومثله سوق الشمّاعين في الرباط، وسوق الشمّاعين في بغداد.
وكانت الأسواق تؤمر بإيقاد الشموع في الاحتفالات السلطانية؛ فقد أمر الحاكم الناس بالوَقيد سنة 394هـ فتزايدوا فيه في الشوارع والأزقة، وزُيّنت الأسواق والقياسر بأنواع الزينة، وأوقدوا الشموع الكبيرة طول الليل.. وكثر وقود المصابيح في الشوارع والطرقات. وأمر الناس بالاستكثار منها وبكنس الطرقات وحفر الموارد وتنظيفها.
جاء في كتاب الوقوف الذي وقفه الحاكم على الجامع الأزهر سنة 400هـ وجامع المقس والجامع الحاكمي ودار العلم فيما يتعلق بالإضاءة وحدها 7 دنانير ثمن نصف قنطار شمع ودينار واحد ثمن مشاقة لسراج القناديل وربع دينار ثمن ملح للقناديل ونصف دينار ثمن خرق لمسح القناديل وثمن عشرة أرطال قِنّب لتعليقها و 37 ديناراً وثلث الدينار ثمن زيت للوقود و 24 ديناراً لمؤونة الناس والسلاسل والقباب والتنانير فوق سطح الجامع، عدا أثمان الحبال والدلاء ومائتي مكنسة وتنوّرين فضة وعشرين قنديلا فضة (28). وكانت نفقات الإنارة في مسجد بغداد في القرن الخامس في شهر رمضان ثلاثة دنانير وثلثاً (29). ويظهر من هذا كله أن تكاليف الإضاءة بالشمع لم تكن مرتفعة، فقد بلغ ثمن القنطار منه سنة 545هـ حسب بعض المصادر ما بين 17 ـ 19 ديناراً، وبلغ في بعض المصادر الأخرى عشرين ديناراً، وباع شمّاع في تلك السنة خمسة أرطال بسعر يتراوح بين دينار ودينار ونصف الدينار (30). والمقريزي يؤكد أن ثمن عشرة أرطال شمع زمن المعزّ دينار ونصف الدينار (31)، أي حوالي ثلاثين درهماً. وحين كان سعره يزيد ـ كما في أول وزارة ابن الفرات ـ قيراطاً من الذهب، فهذا يعني حسب البلاد درهماً واحداً وبعض الدرهم أو أقل من ذلك.
وهكذا كانت الإضاءة بالشموع متوفرة وممكنة، وبخاصة لذوي البسطة واليسار. أما الشموع المكلفة فكانت ثلاثة أنواع:
أ. شموع الشمع العادي الضخمة التي يصل قطرها إلى ما بين 30 ـ 50 سم، وصغيرها يعرف بالمنوية. وكانت توضع في المساجد على جانبي المحاريب، وتزيد في الطول على قامة الإنسان، وفي الوزن على قنطار، وتسمى بالمجلسية. وقد توضع في الميادين العامة أو تُجرّ على العجل في الاحتفالات الكبرى كليالي الوقود. وقد أمر الحاكم مرة فسُبكت له ستون شمعة وزن كل منها سُدس قنطار مصري. وقد أهدى السلطان السلجوقي طغرل بك إلى امبراطور الروم سنة 448هـ/1015م هدية من اللؤلؤ والصيني والأثواب وغيرها وفيها مائة قطعة أنوار فضة بشمع موكبي كبار. والسلطان قلاوون أشعل أكثر من 1500 شمعة مركبية فرحاً بقتل خصمه أحمد بن هولاكو. وابنه خليل حين عاد من الشام أمر أهل الأسواق بالخروج لاستقباله وفي يد كل منهم شمعة موكبية (32).
ب. الشموع الكافورية، وهي غالية الثمن بسبب مزجها بالكافور ورائحته الزكية.
ج. الشموع العنبرية، وهي الممزوجة بمادة العنبر، وقد رأى ناصر خسرو واحدة ضخمة منها، قال: «ورأيتُ في قبة الصخرة شمعة ضخمة يبلغ ارتفاعها نحواً من سبعة أذرع يصل سُمكها إلى ثلاثة أشبار، أشد بياضاً من الكافور مخلوطة بالعنبر، تملأ المكان برائحة العنبر الفواح عندما تضاء. ويقولون إن سلطان مصر بعث هذه الشمعة مع ما اعتاد إرساله كل عام من الشموع الكثيرة النادرة»(33).
وكان بعض الموسرين يوقد شمع العنبر ليلاً، وفي عُمان يذكرون أن يوسف بن الوجيه العماني كان يوقده في مجالسه (34). أما في الأحوال العادية فكان الشمع هو ضوء الخلفاء وغيرهم. وقد ذكر الشابشتي في «الديّارات» أن زبيدة زوجة الرشيد أوقدت ثلاث شمعات من العنبر في عرس المأمون على بوران، فلما كاد الحفل أن ينتهي قالت لجواريها: إن فيما ظهر من المروة والكرم الكفاية، ارفعوا شمع العنبر وهاتوا الشمع (35).
وشموع الكافور والعنبر كانت تختص بالاحتفالات الكبرى كأعراس الملوك والوزراء، وهي التي استعملت في أعراس الرشيد والمأمون والمعتضد، فأوقد الأول لزبيدة شموع العنبر، وأوقد المأمون في عرس بوران شمعة عنبر فيها أربعون منّاً في ثور من الذهب (36). وزاد المعتضد حين تزوج قطر الندى فأوقد أربع شمعات من العنبر في أربعة أتوار من الذهب كانت محفوظة في خزانة الخلافة، فجاءت إليه عند العشاء وقدّامها أربعمائة وصيفة، في يد كل منها تور ذهب وفضة وفيه شمعة عنبر.
وكان ثمة أنواع أخرى من الشموع كالموكبية (وتكون طويلة ثخينة القطر وقد تُحمل على العجل) والفانوسية (وهي صغيرة للفوانيس) والثلاثية (المثلثة الذبالة) والطوّافة( التي يطاف بها في البيت).
وقد كان للمصابيح والشموع والأتوار خدم في القصور، أو قَوَمة في المساجد يقومون على تنظيفها وصيانتها الدائمة. وكانوا بصورة خاصة في العهد الفاطمي يتقاضون رواتبهم من السلطان. وقد ذكر ناصر خسرو في رحلته قوله: «ولقد لاحظتُ أنه في الشام وحتّى مدينة القيروان توجد أعداد كثيرة من المساجد يتولى الإشراف عليها وكيل السلطان في كل مدينة. وهذا الوكيل يشرف على شؤون المساجد فيؤمّن لها الزيوت والمصابيح والأنواع من الفرش، ويصرف رواتب الأئمة والقوّام والمؤذّنين والفرّاشين وغيرهم كل شهر... وكتب والي الشام ذات سنة خطاباً إلى وكيل السلطان يقترح أن يبدل بالزيت الجيد الزيت الحار وهو رخيص ـ ويستخرج من الفجل واللفت ـ فأجابه وكيل السلطان: أنت لست وزيراً، وإنما عليك تنفيذ ما يُطلب منك، والأمور المتعلقة ببيوت الله لا يجب تغييرها من باب التوفير، والتبديل في هذه الأمور غير جائز» (37). أما في بغداد والمشرق وفي الأندلس، فكان القاضي هو الذي يشرف على شؤون المساجد وشموعها ومصابيحها ونظافتها وقَوَمتها. وينفق على ذلك من أوقافها.
4 ـ الاستضاءة بالنفط (المشاعل):
كان النفط معروفاً قبل الإسلام ومستخدماً على أنه دواء لبعض الإبل وعلى أنه للإحراق. ويبدو أن استخدامه كوسيلة حربية تمّ في العهد الإسلامي. واستخدامه كوسيلة استضاءة قديم ولكنه لم يَشِع إلا في المواكب، وفي المساجد الكبار، لأن لونه ولزوجته ورائحته عند الإحراق كانت تمنع استخدامه كزيت الزيتون وغيره أو كالشمع في إنارة البيوت.
وقد ذكر ابن جُبير أنه سمع عن النفط في العراق ورآه في مكانين: مكان بين البصرة والكوفة، وآخر قال فيه: «مررنا بموضع يعرف بالقيّارة من دجلة وبالجانب الشرقي منها... وهوّة من الأرض سوداء كأنها سحابة أنبط الله فيها عيوناً كباراً وصغاراً تنبع بالقار. وربما يقذف بعضها بِحُباب منه كأنها الغليان ويصنع له أحواض يجتمع فيه، فتراه شبه الصلصال منبسطاً على الأرض أسود أملس صقيلاً رطباً، عطر الرائحة شديد التعلّك فيليص بالأصابع لأول مباشرة باللمس. وحول تلك العيون بِركة كبيرة سوداء، يعلوها شبه الطحلب الرقيق أسود تقذفه إلى جوانبها فيرسب قاراً... وبمقربة من هذه العيون على شط دجلة عين أخرى منه كبيرة أبصَرْنا على البعد منها دخاناً، فقيل لنا: إن النار تُشعل فيه إذا أرادوا نقله فتنشف النار رطوبته المائية وتعقده فيقطعونه قطرات ويحملونه. وهو يعمّ جميع البلاد إلى الشام إلى عكة إلى جميع البلاد البحرية» (38). كما ذكر ابن جبير استخدامه لطلاء سطوح الحمّامات. وثمة موضع آخر للنفط في ساحل بحر القلزم وثمة، وضع ثالث للنفط في باكو من أعمال شيروان على البحر الأسود وقد يستورده المسلمون منها.
وكان ثمة والٍ يتولى نفّاطات العراق واستثمارها. وقد تولاها أحد أصدقاء الشاعر عبدالصمد بن المعدّل فأظهر التِّيه بمنصبه، فقال له عبدالصمد:
| بحفظٍ في عيونِ النفط أحدثتَ نخوةً | فـكيف به لو كان مسكاً وعنبرا ؟! | |
| دَع الكبـر واستـبق التواضعَ إنهُ | قبيح بوالـي النفط أن يتكبّرا (39) |
على أن استخدام المشاعل ـ وهي أوعية تُملأ بالمشاقة من القطن والخرق وتُرفع في أعلى العصيّ بعد سقيها بالنفط ـ انتشر كوسيلة رخيصة للإضاءة في المواكب بجانب شكل النار الجذاب الرهيب فيها. ولم تدخل البيوتَ لما فيها من خطر الحريق، ولكنها شاعت في أيدي الحرّاس ورجال المواكب السلطانية، ويعرفون باسم «الضوية» أو «المشاعلية».


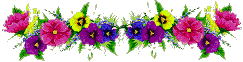

تعليق