هناك كلمة قيّمة لأهل المعرفة وهي: إنَّ الطرق إلى معرفة الله بعدد أنفاس الخلائق بل فوقها بكثير وكثير، فإنَّ لكل ظاهرة من الظواهر الطبيعية وجهين، يشبهان وجهي العملة الواحدة، أحدهما يحكي عن وجودها وحدودها وخصوصياتها وموقعها في الكون، والآخر يحكي عن اتّصالها بعلّتها وقوامها بها ونشوئها منها. فهذه الظاهرة الطبيعية "من الوجه الأول" تقع موضوع البحث في العلوم الطبيعية، فيأخذ كل باحث جهة خاصة من هذا الوجه حسب تخصصه وذوقه واطّلاعه، فواحد يبحث عن التراب والمعادن وآخر عن النبات والأشجار، وثالث عن الحيوان إلى غير ذلك من الموضوعات.
كما أنها من الوجه الثاني تقع طريقاً لمعرفة الله سبحانه والتعرف عليه من ناحية آثاره:
إِنَّ آثارَنَا تَدُلُّ علينَا فَانْظُروا بَعْدَنا إلَى الآثارِ
وبما أنَّ الظواهر الطبيعية، جليلها وحقيرها لها وجهان، فقد أكَّد الإِسلام على معرفتها والغور في آثارها وخصوصياتها، قائلا: ï´؟قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَاواتِ وَ الاَْرْضِï´¾(يونس:101)، لكن لا بمعنى الوقوف عند هذا التعرف واتخاذه هدفاً، بل بمعنى اتخاذ تلك المعرفة جسراً لمعرفة بارئها وخالقها، ومن أوجد فيها السُّنَن والنُّظُم.
إِنَّ الفرق الواضح بين تعرّف المادي على الطبيعة وتعرّف الإِلهي عليها هو أَنَّ الأول ينظر إلى الطبيعة بما هي هي، ويقف عندها من دون أنْ يتخذها وسيلة لتعرف آخر، وهو التعرف على مبادئ وجودها وعلل تكونها، في حين أنَّ الإِلهي، مع أنَّه ينظر إلى الظواهر الطبيعية مثلما ينظر إليها المادي ويسعى إلى التعرف على كل ما يسودها من نُظُم و سُنَن، فإِنَّه يتخذها وسيلة لتعرف عال وهو التعرف على الفاعل الذي قام بإيجادها وإجراء السُّنن فيها، فكأَن النظرة في الأولى نظرة إلى ظاهر الموجود، وفي الثانية نظرة إلى الظاهر متجاوزاً منها إلى الباطن.
وبعبارة أوضح: إنَّ المادي يقتصر في عالم المعرفة، على معرفة الشيء ويغفل عن معرفة أخرى، وهي معرفة مبداً الشيء من طريق آثاره وآياته، فلو اكتفينا في معرفة الظواهر بالمعرفة الأولى حبسنا أنفسنا في زنزانات المادة، ولكن إذا نظرنا إلى الكون بنظرة وسيعة وأخذنا مع تلك المعرفة معرفة أخرى وهي المعرفة الآيوية لوصلنا في ظل ذلك، إلى عالم أفسح ملي بالقدرة والعلم والكمال والجمال. وعلى ذلك فكل المظاهر الطبيعية مع ما فيها من الجمال والروعة ومع ما فيها من النُظم والسُنن آيات وجود بارئها ومكونها ومنشئها، وعند ذلك يتجلى للقارئ صدق ما قلنا من أنَّ الطرق إلى معرفة الله بعدد الظواهر الطبيعية بدءاً بالذرة وانتهاء إلى المجرة. ولأجل ذلك نرى أنَّ رجال الوحي ودعاة التوحيد يركّزون في معرفته سبحانه على الدعوة إلى النظر في جمال الطبيعة وروعتها فإِنها أَصدق شاهد على أَنَّ لها صانعاً ومبدعاً، وهذا مشهود لمن طالع القرآن وتدبّر في آياته. فهو من خلال توجيه الإِنسان إلى الطبيعة وإلى السماء والأَرض وما فيها من كائنات، يريد هدايته إلى مبدئها، ويكفي في ذلك قوله سبحانه: ï´؟إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَـاوَاتِ وَالاَْرْضِ وَاخْتِلافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الاَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّة وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالاَْرْضِ لآَيَات لِّقَوْم يَعْقِلُونَï´¾(البقرة:164).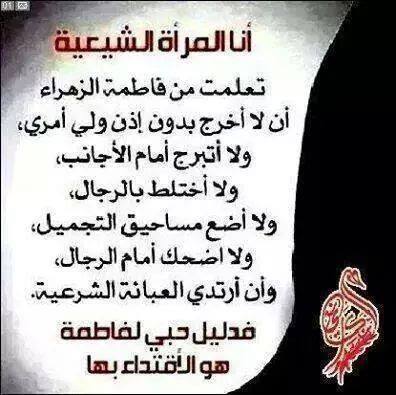
كما أنها من الوجه الثاني تقع طريقاً لمعرفة الله سبحانه والتعرف عليه من ناحية آثاره:
إِنَّ آثارَنَا تَدُلُّ علينَا فَانْظُروا بَعْدَنا إلَى الآثارِ
وبما أنَّ الظواهر الطبيعية، جليلها وحقيرها لها وجهان، فقد أكَّد الإِسلام على معرفتها والغور في آثارها وخصوصياتها، قائلا: ï´؟قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَاواتِ وَ الاَْرْضِï´¾(يونس:101)، لكن لا بمعنى الوقوف عند هذا التعرف واتخاذه هدفاً، بل بمعنى اتخاذ تلك المعرفة جسراً لمعرفة بارئها وخالقها، ومن أوجد فيها السُّنَن والنُّظُم.
إِنَّ الفرق الواضح بين تعرّف المادي على الطبيعة وتعرّف الإِلهي عليها هو أَنَّ الأول ينظر إلى الطبيعة بما هي هي، ويقف عندها من دون أنْ يتخذها وسيلة لتعرف آخر، وهو التعرف على مبادئ وجودها وعلل تكونها، في حين أنَّ الإِلهي، مع أنَّه ينظر إلى الظواهر الطبيعية مثلما ينظر إليها المادي ويسعى إلى التعرف على كل ما يسودها من نُظُم و سُنَن، فإِنَّه يتخذها وسيلة لتعرف عال وهو التعرف على الفاعل الذي قام بإيجادها وإجراء السُّنن فيها، فكأَن النظرة في الأولى نظرة إلى ظاهر الموجود، وفي الثانية نظرة إلى الظاهر متجاوزاً منها إلى الباطن.
وبعبارة أوضح: إنَّ المادي يقتصر في عالم المعرفة، على معرفة الشيء ويغفل عن معرفة أخرى، وهي معرفة مبداً الشيء من طريق آثاره وآياته، فلو اكتفينا في معرفة الظواهر بالمعرفة الأولى حبسنا أنفسنا في زنزانات المادة، ولكن إذا نظرنا إلى الكون بنظرة وسيعة وأخذنا مع تلك المعرفة معرفة أخرى وهي المعرفة الآيوية لوصلنا في ظل ذلك، إلى عالم أفسح ملي بالقدرة والعلم والكمال والجمال. وعلى ذلك فكل المظاهر الطبيعية مع ما فيها من الجمال والروعة ومع ما فيها من النُظم والسُنن آيات وجود بارئها ومكونها ومنشئها، وعند ذلك يتجلى للقارئ صدق ما قلنا من أنَّ الطرق إلى معرفة الله بعدد الظواهر الطبيعية بدءاً بالذرة وانتهاء إلى المجرة. ولأجل ذلك نرى أنَّ رجال الوحي ودعاة التوحيد يركّزون في معرفته سبحانه على الدعوة إلى النظر في جمال الطبيعة وروعتها فإِنها أَصدق شاهد على أَنَّ لها صانعاً ومبدعاً، وهذا مشهود لمن طالع القرآن وتدبّر في آياته. فهو من خلال توجيه الإِنسان إلى الطبيعة وإلى السماء والأَرض وما فيها من كائنات، يريد هدايته إلى مبدئها، ويكفي في ذلك قوله سبحانه: ï´؟إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَـاوَاتِ وَالاَْرْضِ وَاخْتِلافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الاَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّة وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالاَْرْضِ لآَيَات لِّقَوْم يَعْقِلُونَï´¾(البقرة:164).


تعليق